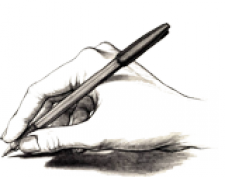معلوم أنّ النظام الرأسمالي الوضعي مُتمثّلاً بطبيعته المادية الأنانية، وآلياته الخادمة للنخب الثرية في الدول الرأسمالية هو المسبّب الرئيسي لكل المشاكل الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدول الرأسمالية بشكلٍ دوري ومُتكرّر، فبسبب سوء توزيعه للثروة الناجم عن التفسير العجيب المغلوط للندرة النسبية، وبسبب اعتماده الكلي على الربا في كل النشاطات المالية البنكية، وبسبب استبعاده للذهب والفضة في العملات الرسمية للدول والاستعاضة عنهما بالعملات الورقية الإلزامية، وبسبب تهويل دور الملكية الفردية على حساب الملكية العامة، وبسبب منح البورصات دور الوصي على كل الأنشطة الاقتصادية للشركات الخاصة والمؤسسات العامة في جميع دول العالم الخاضعة للرأسمالية العالمية، بسبب ذلك كله تحدث مثل تلك الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية التي نشهدها في الاقتصاد العالمي كل عقد زمني يزيد قليلاً أو ينقص.
صحيحٌ أنّ هناك أسباباً خاصة تنشأ ضمن ظروف طارئة واستثنائية تتسبّب في حدوث مثل تلك الأزمات، وهي ليست ناشئة عن النظام الرأسمالي بشكلٍ مُباشر وذلك كالأزمة الحالية التي هبطت فيها أسعار النفط في أمريكا إلى ما دون الصفر، كوفرة المعروض من النفط في الأسواق بسبب جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق المرافق الصناعية والاقتصادية في كل أنحاء العالم، وأدّى ذلك إلى قلة الطلب، وامتلاء الخزانات، وعدم وجود إمكانية لتصريف مُشتريات النفط في العقود الآجلة التي حان استلامها، صحيحٌ أنّ مثل هذه الأسباب ليست ناشئة عن النظام الرأسمالي مُباشرة، لكنّ هذا النظام قد أظهر عجزه الكامل عن التعامل معها.
لقد كان للأسواق المالية (البورصات) الدور الأكبر في مفاقمة المشكلة المتعلقة بنزول أسعار النفط في أمريكا إلى سالب 37 دولاراً للبرميل الواحد، كما كان لهذه الأسواق الدور الأكبر في نزول مؤشراتها بشكلٍ حاد خاصة مؤشرات البورصات العالمية الكبرى كالفايننشال تايمز البريطاني في لندن، وداكس الألماني في فرانكفورت، وكاك الفرنسي في باريس، ونيكي الياباني، وكالمؤشرات الأمريكية الثلاثة وهي داو جونز ونازداك وستاندرد آند بورز والتي هبطت كلها بمستويات ملموسة.
إنّ هذه البورصات كانت دائماً بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير في وقت حدوث الأزمات والانهيارات، فالكساد الكبير في العام 1929 وأزمة الرهن العقاري في العام 2008 وكل الأزمات المتعددة في الأيام السود كانت البورصات هي مصدرها ومنشأها، فهي تُنشئ اقتصاداً طفيلياً ووهمياً، فهو طفيلي لأنّه يتغذّى من الاقتصاد الحقيقي فلا يملك وسائل ذاتية للإنتاج، وهو وهمي لأنّه يُنتج أموالاً بغير جهد ولا توجد لها أصول على أرض الواقع، وبالتالي فهي أموال غير حقيقية، وهي مجرد أرقام مكتوبة على شاشات الحواسب الآلية.
وهذا الاقتصاد الناشئ عن أسواق المال يبلغ أضعاف الاقتصاد الحقيقي، ويؤدي كل فترة زمنية إلى ما يُسمّى بالفقاعة المالية التي يجب أن تنفجر في وقت من الأوقات لكي لا يتباعد الاقتصاد الوهمي كثيراً عن الاقتصاد الحقيقي، وهذا الانفجار هو الذي يتسبّب في الأزمات التي يذهب ضحيتها عادة صغار ملاكي الأسهم، بينما لا يتأثر بها كبار المساهمين.
وعمليات البيع والشراء التي تتم بداخل هذه الأسواق مُنفصلة تماماً عن الواقع، فهي تجارة بلا تقابض، فقد ترتفع فيها قيمة الأسهم أو تنخفض لأسباب لا علاقة لها بالإنتاج الحقيقي كالإشاعات أو كتصريحات لبعض المسؤولين أو لتسريب معلومات تجارية مُضلّلة أو ما شاكل ذلك من دعايات وأكاذيب، وأبرز ما يجري فيها هو المضاربات التي هي أشبه ما تكون بالقمار، فيتم من خلالها تخفيض ورفع الأسعار للبيع والشراء بقصد التحايل، ممّا يفقد الأسهم قيمتها الحقيقية، أو يرفع قيمتها كثيراً بهدف الكسب السريع، ويكون المضاربون الكبار ممّن يمتلكون الأموال الكثيرة والخبرات الموفورة، سواء أكانوا من الأشخاص الأثرياء أو من المؤسسات المالية المتخصصة المشهورة من بنوك ومصارف مثل السيتي بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي وتشيس مانهاتن وغيرها.
فهذه البورصات على ضخامة وفخامة مبانيها، وعلى طرازات أشكالها الفارهة الوثيرة، وعلى ما تملك من إمكانيات ضخمة، فهي لا تُقدّم في الواقع سوى اقتصاد كاذب وهمي، ولا تصنع إلا واقعاً مُزيّفاً للاقتصاد العالمي.
والمصيبة أنّ جميع الدول الرأسمالية جعلت منها قيّماً على الاقتصاد الحقيقي، بل واشترطت على جميع الشركات أنْ يتم تداول أسهمها فيها، فهي تملك الوصاية والحكم على جميع القوى الاقتصادية بما فيها الدول نفسها، وهي أيضاً تُلاحق الأفراد وتُغريهم للاشتراك في نشاطاتها بدون فرض الضرائب على الأرباح التي يحقّقونها، والهدف هو إخراج نقودهم ولو كانت قليلة من جيوبهم وتجميعها والاستفادة منها لتصب في جيوب كبار المساهمين.
إنّ هذه الأسواق المالية ما هي في الواقع سوى لعنة على الاقتصاد العالمي لأنّها في حقيقتها تُمثّل سبباً دائماً لوقوع الأزمات المالية والاقتصادية، ولأنّها تُزيّف الواقع الاقتصادي باستمرار، وتُبرزه بصورة على غير صورته الأصلية، فتزيد الأثرياء ثراءً على حساب الفقراء ومتوسطي الدخل.
وسبب نشوء هذه الأسواق المالية الطفيلية وتغوّلها على الاقتصاد الحقيقي هو وجود الشركات المساهمة التي تسمح بمشاركة المال لبعضه البعض دون حاجةٍ لوجود البدن، لأنّ الشركة في نظامهم تكون من قبيل الإرادة المنفردة وليس من قبيل الاتفاق بين الشركاء، لذلك يتم فيها إغفال دور الجهد الذي يقوم به شريك البدن، كما يتم إلغاء وجود الإيجاب والقبول بين الشركاء للقيام بالعمل المالي، فتتحول الشركة إلى مجرد التزام بدفع الأموال من دون أن يكون فيها أي دور للشركاء، ويتولى الموظفون فيها من غير الشركاء القيام بأعمال الشركة، وهو ما أدّى إلى تجميع هذه الشركات المساهمة في أسواق مالية كبيرة أدّت إلى ما نشهده من كوارث اقتصادية ومالية على مستوى العالم.
إنّ نظام الاقتصاد في الإسلام عندما حرّم الشركات المساهمة لأنّها مخالفة لشروط الشركات في الإسلام فإنّه قد حرّم تلقائياً ما تولّد عنها من أسواق مالية، فالإسلام اعتبرها شركات باطلة لأنّها لم تنعقد أصلاً، وذلك لعدم وجود شركاء فيها، أي لعدم وجود بدن مُتصرّف، ولعدم وجود اتفاق بين الشركاء على القيام بعمل مالي مُحدّد بقصد الربح، إذ لا يوجد فيها إيجاب وقبول، ولا يوجد فيها بدن مُتصرف، لذلك اعتبرها الإسلام شركات باطلة، لا يجوز للمسلمين الاشتراك فيها، وبطلانها ترتب عليه بطلان ما بُني عليها من أسواق مالية، وما بُني على الباطل فهو باطل.
إنّ تطبيق النظام الإسلامي في الشركات يمنع وجود الاقتصاد الطفيلي ويمنع وجود صناعة المال من لا شيء، ويمنع وقوع الأزمات الاقتصادية المتكررة، ويحافظ على وجود اقتصاد حقيقي دائم، ينال منه الأفراد والدول بقدر ما يشاركون فيه بجهود حقيقية تحفظ للكل حقوقه، ويمنع الإثراء السريع، ويوزع الثروة على الجميع بشكلٍ عادل.