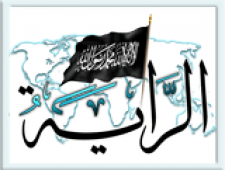في خطوة وصفها البرلمان المصري بالتاريخية، أقر مجلس النواب في جلسة الأربعاء 2 تموز/يوليو 2025 مشروع قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والصراع بين مصالح الملاك والمستأجرين. لكن من ينظر إلى هذا القانون بعين الإسلام، ويقيّمه بمقياسه لا بالمقياس الرأسمالي، يدرك أن ما جرى ليس إصلاحاً وإنما هو تثبيت لمسار مضلل يُحكّم نظاماً بشرياً جائراً ويهدر حق الرعاية الشرعية التي أوجبها الإسلام على الدولة.
لقد جاء هذا القانون وفق ما أعلنه مجلس النواب ووسائل الإعلام ليقضي على نظام الامتداد القانوني للإيجار السكني، ويحدد مهلة انتقالية بخمس سنوات ترفع خلالها الإيجارات تدريجياً وصولاً إلى معدلات السوق، ثم يلزم المستأجر بالإخلاء إن لم يبرم عقداً جديداً. ونص القانون صراحة على مضاعفة الإيجار الحالي خمس مرات فوراً، ثم زيادته سنوياً بنسبة 15% حتى انتهاء المدة، ليتم بعد ذلك تحرير العلاقة. واستثنى فقط بعض الفئات كالمرضى وكبار السن فوق السبعين عاماً، على أن يمدد لهم الإيجار ثلاث سنوات إضافية.
إن من أخطر ما جاء في مواد القانون أنه لم يكتف بتحرير العلاقة الإيجارية دون ضمان حقيقي لتأمين المأوى، بل حمّل ملايين المستأجرين أعباء تضاعف الإيجار فوراً، في ظرف اقتصادي منهك يعيش فيه الناس تحت وطأة الغلاء وتحرير الجنيه وسياسات الاقتراض من صندوق النقد. وقد اعتبر عدد من النواب والإعلاميين والحقوقيين، مثل النائب ضياء الدين داود، أن القانون بهذا الشكل هو تشريد مقنن لملايين الأسر الفقيرة، وإفراغ لمفهوم السكن الآمن المستقر، إذ ستجد عائلات تسكن منذ ستين عاماً نفسها فجأة ملزمة بدفع إيجار يفوق معاشاتها ورواتبها عشرات المرات، ثم الإخلاء أو التهجير بعد خمس سنوات.
هذا الواقع لا علاقة له بما يجب أن تكون عليه الرعاية في الإسلام. فالدولة الإسلامية ليست سمسار عقارات ولا جابي ضرائب لصالح قلة من كبار الملاك أو المستثمرين العقاريين، بل هي مسؤولة عن ضمان سكن كل فرد من أفراد الرعية بكرامة، ولا تترك أحداً يبيت في العراء أو يضطر لاستجداء المأوى، قال ﷺ: «وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
وهذه المسؤولية ليست شعاراً بل هي سياسة حكم، تقتضي من الدولة أن تكفل سكن الناس، وأن تمنع الاحتكار واستغلال حاجة الناس. أما في هذا القانون، فالدولة اكتفت بأن تعدهم بصندوق إعانة لم تتضح آلياته ولا موارده، بينما شرعت بوضوح في رفع الإيجارات وتهيئة سوق العقار لتجار الاستثمار، بحجة "تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر".
وإن الناظر في خطاب الحكومة والبرلمان يجد أن جوهر الدوافع الحقيقية لهذا القانون لا ينفصل عن سياسات الخصخصة والتحرير الاقتصادي التي تمليها المؤسسات الدولية. فالدولة تريد رفع قيمة العقارات لتعزيز الضرائب العقارية، وجذب الاستثمارات، وضخ مزيد من الأموال في السوق العقاري المتضخم على حساب فقراء المدن. وما يشار إليه هنا أن تحرير العلاقة الإيجارية قد يرفع سعر العقارات بنحو 20-30% فوراً، أي تضخم جديد.
ثم إن القول بأن هذا القانون يعالج مشكلة الملاك هو قول يجتزئ الحقائق. نعم، هناك ملاك مظلومون بواقع الإيجارات المجمدة منذ عقود، لكن معالجة هذا الظلم لا تكون بظلم أكبر، أي بتحميل ملايين الناس فوق طاقتهم وإلقائهم إلى المجهول. بل المعالجة تكون - لو كانت الدولة ترعى شؤون الناس حقا - بتسوية عادلة لا تهدم حق السكن، وبضمان من بيت مال المسلمين لكل محتاج. فهذه مسؤولية الدولة وواجبها تجاه رعاياها الذي كفله الشرع؛ كفاية الناس في المأكل والملبس والمسكن. فما بال الناس يشرَّدون ويضطرون ويقال لهم "هذا توازن مصالح"؟!
إن هذه القوانين جزء من بنية النظام الرأسمالي، الذي يعتبر العقار سلعة للربح قبل أن يكون ضرورة حياة. ويعامل الناس باعتبارهم أرقاماً في سوق العرض والطلب لا باعتبارهم بشرا لهم حق الرعاية. وفي حين تزعم الحكومة أنها "تحمي غير القادرين" بمنحهم مهلة إضافية 3 سنوات وصندوق دعم، فهذه مهلة لا تغيّر شيئاً من حقيقة المصير الذي ينتظرهم بعد نهايتها، ولا من حقيقة أن القانون لا ينطلق من واجب شرعي حقيقي بتأمين السكن لهم إلى الأبد إن هم عجزوا عن تأمينه بأنفسهم. وتأمين المسكن والمأكل والملبس من الحاجات الأساسية التي أوجب الإسلام على الدولة توفيرها لكل فرد من أفراد الرعية، كفالةً لا تفضلاً، فإن عجز الفرد عن تحصيل رزقه، وجب على الدولة أن تؤمّن له حاجاته الأساسية، ومنها السكن، من بيت المال. قال ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا».
والإيجار هو معاوضة بالتراضي، لكن إن كانت الحاجة ملحة، والدولة لا توفر البديل، فلا يجوز شرعاً أن ترفع الأسعار لتخرج الناس من بيوتهم للعراء. ومن هنا، يتبين أن هذا القانون ليس رعاية لشؤون الرعية، بل هو إدارة للأزمة على الطريقة الرأسمالية، التي تجعل الناس بين نارين: إما قبول التكاليف الباهظة أو القبول بالطرد! وهو قانون يرضي كبار الملاك والشركات العقارية، بينما يفتح الباب لاستثمارات جديدة على أنقاض استقرار ملايين الأسر. وهو حل جديد من الدولة لأماكن يرى فيها إمكانية الاستثمار أو البيع كما حدث في ماسبيرو ويحدث في جزيرة الوراق وغيرهما، وكما قلنا سابقا فأي منطقة سيلمح فيها النظام إمكانية الاستثمار أو البيع فهي ماسبيرو ووراق!
إن الواجب على الدولة في هذا الشأن يتلخص في:
1- ضمان السكن لكل أفراد الرعية، وليس فقط بتسهيل القروض بل بتسهيل تملك الأرض أو البناء أو دفع بدل الإيجار من بيت المال.
2- إبطال الاحتكار والربح الفاحش، فلا يترك العقار للمضاربة.
3- عدم إخراج المستأجر العاجز عن الدفع إلا بعد توفير البديل الملائم. وعدم تحميل الناس أية أعباء جديدة.
4- الفصل في النزاعات بعقود الإيجار وفق الأحكام الشرعية وليس وفق تشريعات بشرية.
أما هذا القانون، فهو خطوة جديدة في سياسة التنصل من مسؤولية الدولة، وبيع أصول الرعاية، وتكريس السوق حَكماً على حياة الناس، وهي سياسات يرفضها الإسلام جملة وتفصيلاً.
إننا نشهد اليوم مأساة أخرى تضاف إلى مسلسل التردي الذي يعيشه الناس تحت سلطان الأنظمة الرأسمالية، فبينما تُخصص المليارات لمشاريع الرفاهية والاحتفالات الكبرى وتفخيم العاصمة الإدارية، يُترك الملايين في مواجهة شبح الإخلاء، بلا ضمان حقيقي.
وإن التغيير الحق لا يكون بتعديل فقرة أو مدّ مهلة، بل بإقامة نظام الإسلام؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، الذي يجعل رعاية شؤون الناس - كل الناس - فرضاً شرعياً لا رفاهية ولا دعاية انتخابية، ويجعل حق المسكن المأمون في طليعة حقوق الرعية، لا سلعة تباع وتشترى على موائد البرلمان!
بقلم: الأستاذ محمود الليثي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر