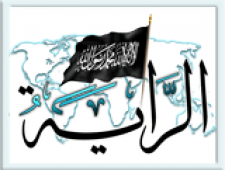(مترجم)
إن اندفاع الغرب المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي عبر تضخيم القدرة الحاسوبية يعكس تصوراً مغلوطاً للذكاء، إذ يُفترض خطأً أن الإدراك مجرد عمليات حسابية بحتة. غير أن الواقع يُثبت أنه بعد حد معيّن، لا تُفضي الزيادات الهائلة في القدرة الحاسوبية (FLOPs) إلا إلى تحسينات طفيفة، لا إلى قفزات نوعية في مستوى الذكاء. فعلى سبيل المثال، تطلّب تدريب نموذج "تشات جي بي تي-4" ما يقدَّر بــ62 ألف ميغاواط/ساعة من الكهرباء وعشرات الملايين من الدولارات في تكاليف الحوسبة، ومع ذلك ما يزال يفتقر كثيراً إلى طاقة الاستدلال العام لدى الدماغ البشري، الذي يتميز بقدرة أعظم على التكيّف وهو لا يستهلك سوى نحو 20 واطاً فقط.
إن اختزال الفكر الإنساني في أبعاده المادية، منزوعاً من جوهره الحيّ والعضوي، خطأ جسيم غذّى الوهم الغربي بأن مزيداً من الحواسيب والطاقة يمكن أن يكرّر عملية التفكير البشري، بل ويبلغ مرحلة "الذكاء العام الاصطناعي". وهذا المنهج الاختزالي، المتجذر في المادية، يعكس إرثاً علمياً غربياً أوسع يقوم على الانشغال بكيفية وقوع الظواهر، مع إغفال أسئلتها الجوهرية: "لماذا؟". ومن هنا نشهد الخلل نفسه في النظريات السائدة حول الانفجار العظيم، ونشأة الحياة، وأصل الإنسان؛ إذ تُفسَّر الأسباب ضمن المبادئ الميكانيكية العامة على طريقة "هوبز"، بينما تظل الغاية النهائية والأسئلة الميتافيزيقية بلا جواب.
يشير مصطلح "البدئي (Primordial)" إلى الحالة الأولى أو الأصلية التي انبثق منها كل شيء. ففي علم الكونيات، يُقصد به الحالة الأولى للكون بعد الانفجار العظيم، المملوءة بالجسيمات والطاقة الأولية. وفي علم الأحياء، يشير إلى "الحساء البدئي" المفترض من الجزيئات البسيطة التي يُظن أنها تجمعت ذاتياً لتفتح الطريق أمام نشأة الحياة. أما فيما يتعلق بالإنسان، فإن "البدئي" يُساق لتفسير نشأة الطبيعة البشرية المعقدة عبر مسار تطوري من كائنات أدنى. بيد أن "الذكاء البدئي" في الحقيقة هو الوعي الحيّ الأصيل الملازم للإنسان، في مقابل محاكاة الذكاء الاصطناعي الحسابية.
لقد حقق العلم خطوات في نمذجة "الكيفية" لهذه البدايات: تمدد الكون، المسارات الكيميائية للأرض المبكرة، نشاط الدماغ العصبي. لكنه أخفق في الإجابة عن "الغاية": لماذا وُجد الكون؟ لماذا نشأت الحياة؟ لماذا وُجد الإنسان؟ وماهية الذكاء الحقّ وراء مجرد معالجة البيانات والتعرّف المعقد على الأنماط؟ هذه الأسئلة النهائية وجودية وميتافيزيقية، عصية على الرصد والتجريب. وإن فشل العلم في الإجابة عنها ليس عرضياً، بل هو راجع لطبيعة منهجه نفسه الذي يحصر نفسه في الظواهر المشاهدة والقابلة للقياس والتكرار، متجنباً العوالم الذاتية وغير القابلة للاختبار. وهذا التفكير - فضلاً عن كونه قاصراً - يظل عرضةً للخطأ، ولا يصلح أن يكون أساساً للحقيقة.
ومثال ذلك نظرية "الحساء البدئي"، إذ كشفت عقود من الأبحاث عن إشكاليات خطيرة من مثل الافتراضات الخاطئة عن تركيب الغلاف الجوي المبكر للأرض، وغياب آلية طبيعية معقولة لتكوّن اللبنات الأولى للحياة تلقائياً. وهذه المعضلات تكشف حدود المنهج العلمي حين يطرق أبواب الأصول الأولى.
إن إيمان الغرب الأعمى بأن تضخيم القدرة الحاسوبية كفيل بإطلاق "ذكاء حقيقي" ما هو إلا انعكاس لذلك الاختزال العلمي المادي، وهو وهم يخلط بين معالجة البيانات وفهم واعٍ أصيل، فيغفل عن عمق الذكاء الإنساني الذي ينخرط في البعد الأخلاقي والوجودي والميتافيزيقي المتجاوز للعلم. أما المنظور الإسلامي، فيفهم هذه البدايات الكبرى - من الانفجار العظيم، إلى خلق الحياة، إلى نشأة الإنسان، إلى منح الذكاء - على أنها أفعال خلق مقصودة من الله تعالى، الواجب الوجود وخالق الكون والإنسان والحياة. وقد جاء في القرآن الكريم أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقتا، وهو وصف ينسجم مع نموذج الانفجار العظيم، لكنه يُظهر تدبيراً إلهياً لا مصادفة عمياء. والحياة خُلقت بأمر الله من الماء والعناصر. والإنسان - وهو أكرم المخلوقات - مُنح العقل والوعي بإرادة الله، فتميّز بوجود هادف. فالإسلام يردّ السببية النهائية إلى الله، مؤكداً أن الوصف العلمي للآليات لا ينفي التدخل الإلهي، وأن سؤال "الغاية" يُجاب عنه عبر الإيمان العقلي بالخالق، بما يتجاوز حدود البحث التجريبي.
وخاتمة القول: إن ضخ مزيد من القدرة الحاسوبية والطاقة والمال في الذكاء الاصطناعي لن يمكّنه من التفكير كالبشر. فالتقدم الحقيقي رهين بتجاوز ضيق العلم التجريبي، وإدراك أن الذكاء هو عملية إدراكية تنقل الواقع عبر الحواس إلى الدماغ، حيث يُفسَّر استناداً إلى معارف سابقة، والمرجع الأعلى لهذه المعارف - في التصور الإسلامي - هو الله سبحانه وتعالى، لا محض التجربة والخطأ. إن هذا المنظور يمكّن العلم من تعريف التفكير تعريفاً صحيحاً، ويضع حدوداً واضحة للذكاء الاصطناعي. وبإرجاع الوجود البدئي كله إلى خالق واحد، يكتمل الفهم، إذ يُتمم الإسلامُ العلمَ ويمنحه بعداً أعمق، يحرره من أسر الاختزال الميكانيكي إلى رحابة الغاية والمعنى والجوهر. ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾.
بقلم: الأستاذ عبد المجيد بهاتي – ولاية باكستان