يقدَّم النظام الديمقراطي اليوم بوصفه ذروة ما وصل إليه العقل البشري في تنظيم شؤون الحكم، حتى غدا أشبه بالعقيدة التي لا تمس، وكأنها ميزان وليس موزوناً، غير أن قليلا من التأمل يكشف أن الديمقراطية ليست فقط فكرة متناقضة في ذاتها، بل هي نظام يخالف طبيعة الإنسان، ويقوده في النهاية إلى الفوضى والانحدار، لا إلى الحرية والرقي.
فمنذ بدايتها النظرية، تقوم الديمقراطية على شعار لامع يقول إنها "حكم الشعب بالشعب"، غير أن هذا التعريف المثالي سرعان ما انهار أمام الواقع. إذ لا يمكن أن يجتمع ملايين الناس ليشرعوا القوانين بأنفسهم، فكان التحايل أن يُنتخب "ممثّلون" عن الشعب يقومون بالتشريع نيابة عنه. وبهذا التحول العملي، تحول حكم الشعب إلى حكم أقلية صغيرة تتحكم بمصائر الأغلبية تحت لافتة "التمثيل الشعبي". وهكذا، تنتهي الديمقراطية التي تبدأ نظريا بسيادة الشعب إلى سيطرة نخبة محدودة من الساسة وأصحاب المال والإعلام، فتستبدل شرعيةُ الصندوق بشرعية السيف، ويستبدل طغاة منتخبون بالطغاة القدامى. إنها حيلة لغوية أنيقة تخفي في جوهرها استبدادا جديدا يمارَس باسم الشعب لا عليه.
لكن التناقض لا يقف عند البنية السياسية، بل يمتد إلى أصل الفكرة نفسها، من يملك حق التشريع؟ فالديمقراطية تجعل الإنسان هو المرجع الأعلى الذي يضع القوانين لنفسه، فيغدو التشريع انعكاسا لرغبات البشر ومصالحهم المتقلبة. والتاريخ شاهد على أن ما يعد حقا في مجتمع ما قد يعد جريمة في مجتمع آخر، وما يعتبر اليوم حرية يدان غدا باعتباره انحرافا أو كراهية. فالمعايير متبدلة، والمقاييس خاضعة للأهواء والظروف. كيف يمكن لكائن متقلب متناقض أن يكون هو المرجع الأعلى للثبات؟! وكيف يمكن لمن لا يملك الاستقامة في ذاته أن يضع قواعد الاستقامة للبشرية؟! إن فكرة "السيادة للشعب" تتجاهل حقيقة أن الشعوب ليست كيانا واحدا متماسكا، بل مجموعة من الاتجاهات والمصالح المتصارعة، وحين تحسم القرارات بالأغلبية، لا يعني ذلك أنها قرارات صائبة، بل فقط أنها نالت عددا أكبر من الأصوات، وهكذا تتحول السيادة من حكم للعقل إلى حكمٍ للأرقام.
ومع هذا الاضطراب في مبدأ السيادة، تبرز أزمة الحرية التي جعلتها الديمقراطية القيمة العليا، فرفعت شعار "الحرية" في الاعتقاد والرأي والتملك والسلوك. غير أن الحرية حين تفصل عن الضابط الأخلاقي تتحول إلى فوضى، وحين تقدس دون مسؤولية تحرر الغرائز لا الإنسان. لقد أطلقت الديمقراطية العنان لرغبات البشر تحت اسم الحرية، فصار الإنسان عبدا لشهواته، يلهث خلف لذاته كما يلهث الحيوان خلف طعامه ورغباته، بلا غاية عليا ولا مقصد معنوي. باسم الحرية، صار كل شيء مباحا: إنكار الفطرة، وتشويه الأسرة، وتقديس الانحرافات والشذوذ بوصفها اختيارات شخصية. وهكذا، فإن الديمقراطية لم تحرر الإنسان من القيود، بل حررت غرائزه ونفسه الأمارة بالسوء وأطلقت سراح الوحش الكامن داخله.
ومع سقوط الضوابط، ضاع المعنى. فكل نظام بشري يحتاج إلى غاية يتجه نحوها ومعيار يزن به الخير والشر، لكن الديمقراطية، حين جعلت الإنسان مرجع نفسه، أسقطت أي مرجعية تتجاوز مصالحه الآنية. صار الخير ما يرضيه ويلبي رغباته، والشر ما يزعجه، فانحسرت القيم النبيلة وتلاشت الفطرة السليمة. ومن هنا ولد إنسان يعيش بلا بوصلة ولا مرجعية متعالية، تائه في عبثية رغباته وتناقضات تفكيره، محاصر بالفراغ الروحي والاكتئاب واللامعنى. فالنظام الذي وعده بالحرية والكرامة حرمه من الهدف والطمأنينة.
في جوهرها، تفترض الديمقراطية أن الإنسان عقل متزن قادر على إدارة نفسه ومجتمعه بعدل وحكمة، لكن التجربة البشرية تثبت عكس ذلك. فالإنسان كائن محدود، يتأثر بمصالحه ومخاوفه وشهواته، فإذا منح سلطة التشريع بلا ضابط أعلى من هواه أفسد كل شيء من حوله. ليست أزمة الديمقراطية إذن في استبعادها الدين فحسب، بل في سوء فهمها لطبيعة الإنسان نفسه. فالإنسان ليس إلهاً صغيرا ليضع القوانين، ولا آلة عقلية محضة لتدير العالم بعقلانية باردة، بل هو مخلوق يحمل في داخله نزوعا إلى الخير والشر، إلى السمو والانحطاط، ولذا يحتاج إلى مرجعية تضبطه وتوجهه. أما الديمقراطية فباسم الحرية والسيادة كسرت كل قيد يمنع سقوطه، فتركت الإنسان يواجه نفسه بلا هدى ولا ميزان.
لقد ولدت الديمقراطية من وهمٍ نبيل يقول إن الإنسان قادر على حكم نفسه بنفسه، لكنها انتهت إلى واقع مرير أثبت أن الإنسان حين يحكم نفسه يهلكها. فهي نظام لا ينسجم مع فطرته، ولا مع حدود عقله، ولا مع حاجته الفطرية إلى الثبات والمعنى. إنها فكرة جميلة في ظاهرها، لكنها مستحيلة التطبيق في واقع البشر. بدل أن ترفع الإنسان إلى مراتب الكرامة، أنزلته إلى درك الحيوان، فصار يعيش بلا مبدأ ولا ضابط ولا غاية. وهكذا، فإن الديمقراطية في جوهرها نظام ضد الإنسان، وإن رفعت شعاره.
فالإنسان لا يحتاج إلى نظام يساير رغباته، بل إلى نظام يعالجها، ويهذب غرائزه، ويرتقي بإنسانيته من مستوى الغرائز إلى مستوى التكريم. يحتاج إلى منهج شامل يوجه حياته بكل جوانبها، فكرا وسلوكا، فردا وجماعة، دنيا وآخرة. وهذا النظام لا يمكن أن يصدر إلا عن كامل لا يعتريه نقص ولا عجز ولا احتياج ولا جهل، هو الله الخالق الذي أوجد الإنسان والكون والحياة، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.
وحين يمتلك الإنسان تصورا صحيحا عن نفسه وعن الكون الذي يعيش فيه، وعن العلاقة بينهما وبين ما قبل الحياة وما بعدها، يكون قد وضع قدمه على أولى درجات النهوض الحقيقي بإنسانيته. فالنهوض لا يبدأ من الاقتصاد أو الصناعة، أو الثروات، بل من الفكرة التي تحدد معنى الوجود ومغزى الحياة.
ومن هنا، لا بد من عقيدة روحية سياسية تشكل أساسا سليما للنهضة الصحيحة، تجمع بين الإيمان العميق والفكر العملي، وتربط الدنيا بالآخرة ولا تفصل بينهما، إنها العقيدة الإسلامية التي انبثقت من المبدأ الإسلامي، الذي جمع بين العقيدة التي تهدي، والنظام الذي ينظم، المبدأ الذي ينهض بالإنسان حقاً لا وهماً.
بقلم: د. أشرف أبو عطايا



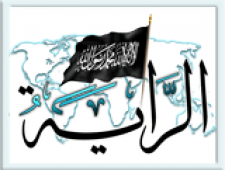


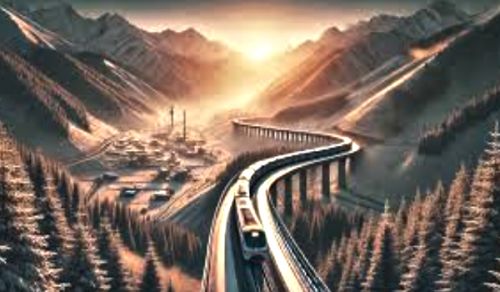













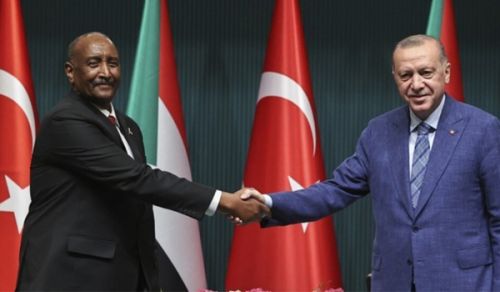








رأيك في الموضوع