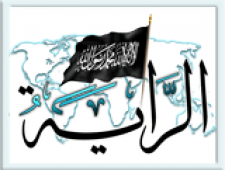لم يكن هدم الخلافة حدثاً تاريخياً عابراً، ولا ذكرى عاطفية يُكتفى فيها بالبكاء والمراثي، بل كان زلزالاً سياسياً وحضارياً لم تشهد الأمة له مثيلاً منذ وفاة رسول الله ﷺ. يومها لم تُهدم دولة فحسب، بل هُدم الإطار السياسي الجامع الذي كان يحفظ الدين، ويصون الأمة، ويوحدها تحت سلطان الشرع. ولذلك صدق أحمد شوقي حين جعل المآذن والمنابر تنوح، وجعل الهند ومصر والشام والعراق وفارس تبكي؛ لأنها أدركت أن ما هُدم لم يكن بناءً عثمانياً، بل كيان الأمة كلها.
في الثامن والعشرين من رجب سنة 1342هـ، الموافق للثالث من آذار/مارس 1924م، اكتملت جريمة مدبّرة بعناية، قادتها الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا، ونُفذت بأيدٍ محلية عبر مصطفى كمال، فأسقطت الخلافة، ولم تخرج الجيوش المحتلة من إسطنبول إلا بعد أن اطمأنت إلى اقتلاعها من الجذور، وإقامة دولة علمانية تفصل الإسلام عن الحكم، وتقصي الشريعة عن الحياة، وتحوّل الأمة من جماعة سياسية واحدة إلى شتات من الدول والحدود.
وبهدم الخلافة لم يسقط سلطانٌ ولا عرش، بل سقطت المفاهيم؛ سقط مفهوم الدولة القائمة على العقيدة، وحلّ محله مفهوم الدولة القائمة على المصالح، وسقطت الأخلاق السياسية، وحلّ محلها النفعية والانتهازية، وسقط ظل دار الإسلام الذي كان يظل المسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها.
والحديث عن هذه الذكرى ليس حنيناً إلى الماضي، ولا اجتراراً للتاريخ، بل هو تشخيص للداء، وبيان لسُنن النصر والسقوط. فدولة الخلافة العثمانية حين قامت، قامت على الجهاد والشرع والانضباط، وحين ضعفت لم يكن ذلك فجأة، بل حين تراكم الانحراف، وأهملت اللغة العربية وأغلق باب الاجتهاد، وتُركت التربية، وتُسومح مع الانحراف العقدي والفكري، فكانت النتيجة نزع التمكين، لأن سنن الله لا تحابي أحداً.
لكن الأخطر من هدم الخلافة ذاته هو ما تلاه، إذ لم يُترك فراغ سياسي عبثاً، بل مُلئ بسدين كبيرين عطّلا نهوض الأمة:
السد الأول: الأنظمة الحاكمة، التي ورثت الاستعمار وحملت مشروعه، فمنعت الأمة بالقوة من استعادة وحدتها وحكمها بالإسلام.
أما السد الثاني، وهو الأخطر: فهو تشويه الوعي من الداخل عبر جماعات إسلامية وغير إسلامية، إما انخرطت في اللعبة التي رسمها المستعمر، أو اختزلت الدين في أخلاق فردية وعبادات معزولة، أو رفعت شعار "إبراء الذمة" لتُقنع الناس أن السكوت، أو العمل الجزئي، أو الاعتزال السياسي، يكفي عند الله! وهكذا جرى تخدير الأمة باسم التدين، وتشويه فكرة الجماعة السياسية المبدئية، مع أن التاريخ والشرع معاً يقرران أن الدين لا يقام بأفراد، والرسالة لا تحمل بلا كيان، ولا تستعاد الأمة بلا جماعة واعية منظمة.
ومن هنا، فإن إحياء ذكرى هدم الخلافة إنما هو لإعادة الاعتبار لحقائق كبرى وهي أن وحدة المسلمين ليست ترفاً، وأن العمل الجماعي السياسي المبدئي ليس بدعة، وأن الخلافة ليست حلماً رومانسياً، بل ضرورة شرعية وعقلية وتاريخية، بها تحفظ البيضة، وتقام الحدود، وتصان الأعراض، وتُحمى الأمة من التفكك والتبعية.
كما أن هذه الذكرى دعوة لربط الأجيال الجديدة بتاريخها القريب، لا لتقف عند عصر الصحابة فقط - مع عظيم منزلته - بل لتدرك أن لهذه الأمة في العصر الحديث تجربة دولة حكمت ستة قرون، وصلت جيوشها إلى قلب أوروبا، وكانت قوة عالمية يحسب لها ألف حساب، وأن ضياع الخلافة لم يكن لأن الإسلام عاجز، بل لأن المسلمين قصّروا وانحرفوا.
والدروس واضحة لا لبس فيها: التمكين مشروط بالطاعة والعدل، وليس بالشعارات، والأعداء يخططون طويلاً، فلا يُواجهون بردود أفعال عاطفية.
ووحدة الأمة مصدر قوتها، ولذلك فُككت، والخلافة لأنها الإطار السياسي الذي يحفظ الدين ويقيم الدنيا، والتربية والوعي العقدي والسياسي شرط الثبات، لا الزينة الخطابية، والعزة كل العزة في الإسلام، وليس في استيراد أنظمة الكفر مهما تلونت بأسماء الحرية والتقدم.
لقد جرّبت تركيا العلمانية كل ما وُعدت به الأمة اليوم: فصل الدين عن الدولة، تغيير الهوية، محاربة الشريعة... فلم تنل عزاً، ولم تُقبل أوروبياً، ولم تصنع مجداً بديلاً، بل فقدت مجدها القديم، وبقيت معلّقة بين عالمين.
لذلك، فإن الواجب اليوم على الأمة الإسلامية قاطبة ليس البكاء على أطلال الخلافة، بل تحويل ذكرى هدمها إلى وعي، والوعي إلى التزام، والارتقاء بكليهما إلى عمل جماعي سياسي مبدئي، حتى تصبح عودتها مطلباً جماهيرياً دائماً، وليس شعاراً موسمياً عابرا، وحتى يبرئ المسلم ذمته أمام الله تبارك وتعالى، ليس بالكلام فقط، وإنما بالسير في الطريق الصحيح لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة مع حزب التحرير الرائد الذي لا يكذب أهله.
بقلم: الأستاذ سامي يحيى – ولاية اليمن