في عالمٍ أنهكته الحروب، تبدو كلمة "السلام" مغرية بما يكفي لتُعلّق فوقها أوسع المشاريع وأكثرها غموضاً. وحين تُستدعى غزة، الجريحة والمنهكة، لتكون عنواناً لمجلس دولي جديد، يتهيأ للمرء أن العالم أخيراً قرر أن ينصت إلى الألم. لكن المفارقة الصادمة أن غزة، التي قُدِّم المجلس باسمها، غابت تماماً عن ميثاقه.
فلا ذكر لقطاع غزة، ولا توصيف لمعاناته، ولا إشارة للمجازر التي ارتكبت فيه، ولا تحديد لمسؤوليات من دمّره. وكأن غزة لم تكن سوى كلمة عبور، ذريعة لتمرير كيانٍ دولي جديد، لا يتحدث عن المأساة بقدر ما يعيد هندسة العالم من فوقها.
لقد أعلن عن "مجلس السلام" بوصفه إطاراً لإعادة إعمار غزة، ثم ما لبث أن كُشف ميثاقه ليحمل مهام أوسع: إدارة النزاعات المسلحة في العالم، وصناعة الاستقرار، وإعادة الحكم الرشيد. وهنا تبدأ الأسئلة الثقيلة بالظهور: متى تحوّل إعمار منطقة مدمّرة إلى بوابة لإعادة تشكيل النظام الدولي؟ ومن الذي منح طرفاً غارقةً يداه بالدماء حق تعريف السلام، وتحديد ساحاته، واختيار أعضائه؟ وكيف بمن يمول الحروب بالسلاح ويغذي الصراعات العالمية ويؤجج نارها أن يلبس عباءة السلام؟!
الميثاق لا يخفي بنيته الحقيقية، فالرئيس ليس مجرد منسّق، بل سلطة عليا: يختار الأعضاء، ويعيّن التنفيذيين، ويفسّر النصوص، ويمتلك حق النقض، بل ويملك وحده قرار حلّ المجلس أو تمديده. فنحن اليوم لسنا أمام منظمة دولية بالمعنى المعروف سابقا وإن كانت صنيعة جهات استعمارية، بل أمام مركز قرار شخصي مُقنَّع بلغة قانونية، يأمر فيه ترامب وينهى وكأنه فرعون هذا الزمان يرى العالم في ملكه والأنهار تجري من تحته.
بهذا المعنى، لا يبدو المجلس امتداداً للنظام الدولي، بل بديلاً عنه. فالأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والقانون الدولي، وكل ما راكمته البشرية من أعراف بعد الحروب الكبرى، يستبدل بها هيكل جديد يُودَع ميثاقه في واشنطن، وتُدار مفاصله بإرادة واحدة، وكأنه إعلان عن نهاية مرحلة، وبداية مرحلة جديدة يقبع فيها العالم تحت رحمة القوة الأمريكية وجبروتها.
الأخطر في الميثاق ليس فقط تركيز السلطة، وإنما تحويل آلام الشعوب ودمائهم إلى صفقات تجارية، حتى يغدو الدم المسفوك مادة للتفاوض، وسهما على شاشة البورصة العالمية، يدر الأموال الفائضة إلى خزينة المتنفذين والمجرمين، وهنا فعلا يتحول استقرار العالم إلى اضطراب وجحيم، وكأن العالم يُقال له بوضوح: من يملك المال يشارك في صناعة السلام، ومن لا يملك، يكتفي بتلقي نتائجه.
أما غزة، صاحبة الجرح المفتوح، فحُصرت في "لجنة تكنوقراط" تدير الشأن اليومي دون سيادة، ودون قرار سياسي، ودون ضمانات! تدار الحياة، لكن لا تدار القضية! يرمم الركام، لكن لا يسأل من الذي هدم! وهكذا يفصل الألم عن سببه، وتعالج النتائج بينما يحمى الجاني من المساءلة.
وحين تتصدر مشهد "السلام" وجوه ارتبطت تاريخياً بإدارة أزمات الشرق الأوسط لا بحلّها، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل يُصنع السلام بالأدوات ذاتها التي صاغت الخراب؟
هذا المجلس، في جوهره، لا يعالج مأساة غزة، بل يستخدمها كنقطة انطلاق لنظام عالمي جديد، عالم تدار فيه النزاعات والصراعات كصفقات تجارية، وتمنح فيه القوة غطاء قانونياً خاصاً بها حتى غدا العالم يسير نحو الفوضى المقننة، عالم يقال فيه للدول لا بقاء إلا للأقوى ولا استقرار إلا لمن يدفع!
ولما وصل العالم اليوم لهذه المرحلة، وهو يدار من مركز واحد، ويختزل في إرادة واحدة، ويجبر على الانصياع لقوة لا تخضع لقانون، وتمارس عليه قوة السيف والغطرسة، إنما يعيد إنتاج اللحظة ذاتها التي سبقت سقوط الإمبراطوريات الكبرى.
فالتاريخ لا يسير في خط مستقيم. والإمبراطوريات، حين تبلغ ذروة شعورها بالقدرة المطلقة، تكون قد بدأت فعلياً مسار أفولها. هكذا كانت فارس، وهكذا كانت الروم، وهكذا كانت كل قوة ظنّت أن العالم يمكن أن يدار بالسيف وحده أو بالقانون المصنوع على مقاسها.
حتى جاء الإسلام والمسلمون فهدموا إمبراطوريتي فارس والروم وقضوا على الاستبداد، والعبودية والتبعية ورسموا العدل في ربوع العالم، حتى وقف رِبعيّ بن عامر رضي الله عنه، أمام رستم قائد فارس ليسطر كلمات تنجي العالم كله من إجرام الفراعنة والمتكبرين: "نحن قوم بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة".
فالعالم اليوم لا ينقذه مما هو فيه ولا يعود له استقرار ولا كرامة ولا عدل إلا بالإسلام ودولة الإسلام؛ الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله.
بقلم: الأستاذ عبد الله النبالي



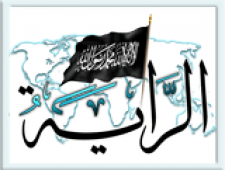

























رأيك في الموضوع