لطالما رُوِّج في البلاد العربية لفكرة مفادها أن الاستقرار السياسي شرطٌ سابق للتنمية الاقتصادية، وأن أي انفتاح سياسي قد يؤدي إلى الفوضى وتعطيل النمو. وأصبحت ثنائية الاستقرار السياسي مقابل التنمية من أكثر الثنائيات حضوراً في الخطاب السياسي العربي منذ مرحلة ما بعد (الاستقلال)؛ إذ جرى الترويج لفكرة أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الاستقرار السياسي، وغالباً ما فُهم هذا الاستقرار بوصفه سيطرةً أمنيةً لصالح الحكام التابعين للدول الغربية عموماً، وغياباً للصراع، لا بوصفه استقراراً قائماً على الشرعية والمؤسسات.
غير أن اللافت للنظر أن كثيراً من الدول التي تمتعت باستقرار سياسي طويل لم تحقق تنمية اقتصادية مستدامة، كما أن دولاً شهدت تحولات سياسية عجزت عن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وهنا تُطرح إشكالية مركزية حول طبيعة العلاقة بين الاستقرار والتنمية: هل هي علاقة شرطية؟ أم تفاعلية؟ أم متناقضة؟ في السياق العربي تحديداً؟
لفهم هذه الإشكالية، نعود إلى حقل الاقتصاد السياسي، حيث تشير الأدبيات إلى وجود علاقة بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، إلا أن هذه العلاقة ليست خطية، بل تعتمد على متغيرات عديدة، منها: نوع النظام السياسي، وطبيعة الحاكم وتوجهاته، والبنية الاقتصادية، سواء أكانت ريعية أم إنتاجية، إضافة إلى وجود أو غياب مؤسسات المساءلة والشفافية. فغياب هذه المؤسسات يؤدي إلى ما يُسمّى استقراراً شكلياً لا ينعكس تنموياً، بل يُنتج فساداً مؤسسياً واختلالاً في توزيع الموارد.
أما في الحالة العربية، فإننا غالباً ما نكون أمام استقرار قسري يؤجل الأزمات ولا يمنعها.
ويمكن إيراد بعض الأمثلة على ذلك:
مصر: رغم تقديم نموذج خلال العقد الأخير يجعل الاستقرار الأمني أولوية مطلقة، ولو بصيغة قسرية قائمة على الحديد والنار، فإن ذلك لم يحقق أي تنمية حقيقية. بل ارتفع الدين العام، وتراجعت القوة الشرائية، واتسعت الفجوة بين طبقات المجتمع، مع تآكل شبه كامل للطبقة الوسطى، ليصبح المجتمع منقسماً بين فقر مدقع وغنى مفرط.
دول الخليج: حققت مستويات عالية من الاستقرار التابع، وتنمية اقتصادية أساسها الريع النفطي، لا المشاركة السياسية أو الاقتصادية. وهو ما يجعل هذا الاستقرار مشروطاً بالقدرة المالية (النفط) لا بالمؤسسات، وقابلاً للاهتزاز مع أي تراجع في الموارد.
الجزائر: تعيش حالة من الاستقرار الجمودي؛ حيث يوجد استقرار سياسي شكلي دون تنمية حقيقية، ما أدى إلى احتقان مجتمعي انفجر جزئياً في حراك عام 2019، ولا تزال البلاد اليوم على أبواب انفجار جديد، في ظل استقرار يؤجل الأزمة ولا يقدم حلاً جذرياً لها.
في الخطاب العربي، لا يُعرَّف الاستقرار السياسي عادة بوصفه سيادةً للقانون، أو تداولاً سلمياً للسلطة، أو مؤسسات قوية ومستقلة، بل يُختزل في معنى واحد هو غياب التغيير بأي شكل، سواء أكان احتجاجياً أم سياسياً، وغياب المنافسة والأصوات المعارضة. وبذلك يصبح الاستقرار في الدول العربية استقراراً قسرياً قائماً على القمع لا على التماسك المجتمعي، وتتحول مؤسسات الدولة من مؤسسات لخدمة المجتمع إلى أجهزة رقابة ونهب وقمع لصالح الفئة الحاكمة.
وتبقى التنمية في هذا السياق مشروعاً مؤجلاً، يُستخدم كأداة وعد وتهديد في آن واحد؛ فهي تأتي بعد الاستقرار الكامل، وبعد القضاء على الفوضى، وبعد إسكات الأصوات الناقدة، وبعد، وبعد... دون أن تأتي أبداً.
ومن هنا نستنتج أن الاستقرار المفروض بالقوة لا يُنتج مؤسسات قوية ذات كفاية عالية، بل يؤسس لشبكات ولاء وفساد، ومع غياب المساءلة والشفافية تتحول موارد البلاد إلى غنائم للفئة المتسلطة بدعم خارجي. ولذلك يُفرض في الدول العربية استقرار بلا تغيير، وتنمية بلا مشاركة، قائمة في الغالب على الاقتصاد الريعي (ثروات خام، مساعدات، تحويلات، قروض دولية...).
وعند قراءة تجارب الربيع العربي، يرى البعض فيها دليلاً على أن التغيير يؤدي إلى الفوضى، غير أن القراءة المتأنية تُظهر أن الانفجار كان نتيجة تراكم طويل لغياب التنمية والعدالة. كما أن الدول التي عادت إلى حالة الاستقرار القديمة دون تغيير حقيقي عادت إليها الأزمات ذاتها ولكن بصورة أشد، كما في حالتي مصر وتونس. فالاستقرار الذي لا يستند إلى شرعية هو استقرار هش، مؤقت، وقابل للانفجار.
الحالة السورية: قبل عام 2011، كانت سوريا تُصنَّف دولياً دولة مستقرة أمنياً بفضل القبضة الأمنية الشديدة. لم يكن هناك تنافس سياسي بسبب القمع المرتبط بنظام أمني متجذر، حافظ على وجوده بالقوة لا بالرضا الشعبي. وقد أسس حافظ الأسد هذا النظام منذ استلامه الحكم، وأقام اقتصاداً قائماً على رأسمالية المحاسيب، فاستُبدلت بالطبقة الوسطى طبقة مرتبطة بالنظام، وتوسع الفقر والقمع لصالح الطبقة الحاكمة وحلفائها.
بعد عام 2011 سقط الاستقرار وانكشف الوهم، وانفجرت الأوضاع، إذ لم تكن هناك مؤسسات مجتمعية ولا اقتصاد تنموي حقيقي. وكان غياب الشرعية واحتكار الاقتصاد من أبرز أسباب الانفجار، فتحولت الدولة إلى ساحة صراع. وفي علم السياسة، يسقط الاستقرار القسري أمام أول صدمة، ولولا الدعم الخارجي لما طال عمر النظام. ومع تدمير البنية التحتية ونهب الموارد، انهار الاقتصاد وتفكك المجتمع، وبقي النظام القمعي قائماً بدعم وتمويل خارجيين.
وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، سقط نظام بشار الأسد بعد 14 عاماً من الحرب، وبدأت مرحلة انتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام، ثم عُيِّن الجولاني رئيساً مؤقتاً للبلاد. غير أن الواقع الحالي يُظهر إعادة إنتاج لمنطق النظام السابق سياسياً واقتصادياً، مع تغيير في النخب والخطاب، لا في جوهر الحكم.
ومن أبرز مظاهر تكرار بنية النظام السابق:
- تركّز القرار في يد شخص أو دائرة ضيقة، وتهميش المؤسسات، وغياب (الفصل بين السلطات).
- مركزية القرار السياسي والأمني، وتأثره بمصادر خارجية لنفس الحالة السورية السابقة.
- شرعية قائمة على منطق "من حرر يقرر"، كما كان سابقاً "من يحمي يقرر"! وفي الحالتين الشرعية تبنى على الخوف.
- رفض التعددية الحزبية وإعادة إنتاج الخوف من السياسة.
- إعادة إنتاج اقتصاد المحاسيب والاحتكار والفساد.
- غياب رؤية اقتصادية وتنموية واضحة، بل كلها إملاءات خارجية بأدوات محلية جديدة والاكتفاء بإدارة الأزمة.
وللإنصاف، هناك أوجه اختلاف لا تُذكر تبريراً بل تفسيراً:
- الحكم اليوم يتم في دولة مدمرة، مفككة، بلا موارد حقيقية، فيها ولاءات خارجية مختلفة.
- لا يوجد حتى الآن قمع شامل نمطي مثل السابق، لكن هناك ضغط أمني متزايد والخوف هو تحوله إلى صدام سني سني بعيدا عن العرقيات الصغيرة التي أصبحت بحماية خارجية.
- خطاب العدالة الانتقالية والدستور ما زال نظرياً أكثر منه عملياً، مع وجود بعضه مطبقاً لصالح العرقيات الصغيرة بضغط خارجي.
بدأ يظهر استبداد جديد باسم الاستقرار ومنع الفوضى، وهو أخطر من الاستبداد القديم، لأنه يولد خيبة أمل عميقة لأهل الثورة ويقضي على آخر رصيد أخلاقي لها، ويزرع بذور انفجار مؤجل.
وعليه، يتبين أن سقوط نظام آل أسد لم يؤد تلقائياً إلى تفكيك منطق الحكم، بل بقي النموذج ذاته مع تغيير في الوجوه. فالاستقرار الذي لا يقوم على تغيير جذري في بنية النظام يظل استقراراً هشاً وقابلاً للانتكاس، مهما ارتدى من شعارات ثورية أو انتقالية.
إن مستقبل المنطقة لن يحدد بقدرة السلطة على فرض النظام، بل بقدرتها على كسر هذا النموذج وبناء نظام قائم على الاستقلال والشرعية والمشاركة، ولا يقبل بالولاءات الخارجية، وأن يكون أساس النظام الجديد قائماً على قاعدة مبدئية تمتلك القدرة على مواجهة التحديات.
ويبقى الشعب السوري هو بيضة القبان في هذا الصراع، وهو ما تخشاه القوى الدولية، ولذلك تعمل على إضعافه. غير أن هذا الشعب يتطلع إلى العدالة والكرامة والحرية، ويرى أن مخرجه هو في العودة إلى تحكيم شريعة الله، وهو ما تعكسه الهتافات والاحتجاجات، ورغم محاولات التعتيم الإعلامي تبقى طبيعة الشعب في بلاد الشام تواقة لاستئناف الحياة الإسلامية.
إن الصعوبات التي نواجهها اليوم هي لفرز الحق من الباطل ليبدأ الصراع الحاسم بين أهل الحق الذين يريدون تحقيق بشرى رسول الله ﷺ بعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، والباطل الصرف الذي كشفته المحن وأسقطت عنه اللثام، فيتحقق وعد الله سبحانه وتعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾.
بقلم: الأستاذ نبيل عبد الكريم



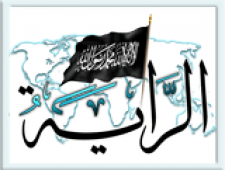

























رأيك في الموضوع