ليس الفساد دائماً خطأً في دفاتر الدولة، ولا عيباً في آلياتها الإدارية، ولا نتيجةً لضعف الكفايات أو نقص الموارد، كما تحاول الدولة في كثير من الأحيان إقناع رعاياها.
ففي بعض البلاد يكون الفساد أكثر انتظاماً من القانون نفسه، وأكثر فاعلية من المؤسسات، وأصدق تعبيراً عن طبيعة الحكم القائم. هناك لا يُدار الفساد في الظل، بل يُدار علناً دون أن يُسمّى، ويُستخدم لا كاستثناء يُعالج، بل كأداة حكم!
يُقدَّم الفساد في الخطاب الرسمي، خصوصاً في الدول التابعة، على أنه انحراف إداري أو سلوك فردي ناتج عن ضعف الرقابة أو خلل القوانين. غير أن هذا التوصيف رغم شيوعه لا يفسر عمق الظاهرة، ولا قدرتها على الاستمرار لعقود، ولا يشرح الفشل المتكرر لمعظم محاولات مكافحته.
وهذا ما يفسر أن الفساد في كثير من الأنظمة ليس خللاً طارئاً، بل أداة حكم مركزية تُدار بوعي، وتُستخدم لضبط النخب، وإعادة توزيع الولاءات، وضمان بقاء السلطة.
في هذا السياق، لا يصح السؤال: لماذا فشلت الدولة؟ بل الأجدر أن يُسأل: كيف نجح النظام في البقاء رغم فشل الدولة؟ وكيف تحوّل المال العام من مورد للخدمة إلى وسيلة للضبط، ومن خلل إداري إلى منطق حكم متكامل؟
وعليه، يمكن تصنيف الدول إلى ثلاثة أنماط رئيسية:
دول سلطوية هشة تابعة: يتحول فيها الفساد إلى نظام موازٍ، بل إلى العمود الفقري للحكم.
دول مستقرة: وهي غالباً الدول الكبرى الخاضعة لقانون وضعي في إطار الرأسمالية، حيث يُعدّ الفساد استثناءً داخل منظومة قانونية تعمل - في الأصل - بكفاية.
وبسبب الدول الكبرى تعيش بلاد المسلمين كلها الفساد، وتعاني منه، والدول الكبرى تحافظ على هذا الفساد لأنها المستفيد الأكبر منه لحماية مصالحها وضمان تبعية الحكام لها.
دول مبدئية: تغيّر تربة الفساد ذاتها، فلا تسمح له بالنمو أصلاً.
وسنعرج على كل نمط على حدة.
أولاً: الفساد من أداة حكم إلى تربة سياسية
في هذا النمط من الدول، لا يُناقش الفساد بوصفه خطيئة أخلاقية، بل باعتباره خياراً سياسياً وبنية حكم. تعتمد هذه الأنظمة على توازن دقيق بين مراكز قوى متعددة: عسكرية، اقتصادية، قبلية، حزبية أو طائفية... وبما أنها تفتقر عادةً إلى شرعية مؤسسية حقيقية، فإنها تلجأ إلى الفساد كوسيلة لضمان الولاء.
يُسمح بالاستيلاء على المال العام، والتحكم في العقود، والتهرب من المحاسبة، لكن هذا "السماح" ليس متاحاً للجميع، بل مشروط بالولاء السياسي. وهنا يصبح الفساد سيفاً ذا حدّين: مكافأة للموالين، وأداة ابتزاز دائمة لهم، إذ يمكن فتح ملفاتهم في أي لحظة.
أما حملات "مكافحة الفساد" في هذه الدول، فغالباً ما تكون مسيّسة منذ انطلاقها؛ تستهدف الأفراد لا النظام، وتُستخدم لتصفية خصومات داخل النظام نفسه. ولا تتحرك هذه الحملات إلا عند تغيّر موازين القوى، أو الحاجة إلى إعادة ترتيب النخب، أو توجيه رسائل ردع لأطراف بعينها. وهكذا تتحول مكافحة الفساد إلى أداة سياسية بحتة، لا إلى مشروع إصلاحي حقيقي.
في هذه الدول، لا تقوم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على الضرائب والمساءلة، بل على توزيع الريع. فيُمنح الفساد في صورة عقود حصرية، واحتكارات استيراد، وأراضٍ وعقارات، ومناصب تُوزّع للنهب على أساس الولاء لا الكفاية. كما تُمنح الأجهزة الحساسة، الأمنية والعسكرية (عصا الدولة)، امتيازات اقتصادية وحصانة من المحاسبة، لا غفلةً من النظام، بل لأن بقاءه مرتبط ببقائها مستفيدة.
وعند حدوث خلاف داخل النخبة الحاكمة، تظهر فجأة قضايا فساد "محكمة" عبر تسريبات مدروسة، ما يؤكد أن الفساد كان معلوماً ومقبولاً، لكن موقع صاحبه في ميزان القوة قد تغيّر. وغالباً ما تكون هذه الأنظمة مرتبطة بدولة كبرى تتبع لها، وحتى في حالات الصراع الدولي، يتغير الأشخاص ولا يُستبدل النظام.
ويمثل هذا النمط معظم الدول العربية، وأمريكا اللاتينية، وأجزاء من آسيا، وأغلب دول أفريقيا؛ أي الدول التابعة بنيوياً.
والمؤسف أن دول "الربيع العربي" أو التي شهدت تغييراً في أنظمة الحكم، عادت في الغالب إلى سابق عهدها، وكأن لا نموذج مسموح بتطبيقه في بلاد المسلمين سوى الفساد كأداة حكم، والتبعية كقدر محتوم، وهو ما يحرص عليه الغرب.
ولا تسقط أنظمة الفساد عندما يزداد الفساد، بل عندما يعجز النظام عن توزيع الغنائم، فتختل شبكة الولاءات، وتظهر قوة خارج المنظومة لا يمكن احتواؤها بالفساد. حينها تسعى الدول المهيمنة إلى ركوب الموجة، وإعادة إنتاج الفساد بوجوه جديدة، إلا في حالة التغيير الجذري الحقيقي.
ثانياً: الدول المستقرة
وهي الدول الكبرى التي يقوم نظام حكمها على القانون الوضعي. الفساد موجود فيها، لكنه انحراف داخل النظام لا أداة له. في أغلب هذه الدول، يُكشف الفساد ويُحاسَب، ولا توجد - نظرياً - حماية سياسية مطلقة، ولا أحد فوق القانون.
غير أن هذا يستثنى عند المصالح الكبرى، حيث يجري الالتفاف عبر المال السياسي، واللوبيات المؤثرة، ومن هم فوق السلطة الرسمية (الدولة العميقة).
تحاول هذه الدول محاربة الفساد دون اقتلاعه، إذ يبقى متغلغلاً في ثنايا القانون الوضعي القائم على الحلول الوسط، وهو في جوهره قانون يشرعن أنواعاً متعددة من الفساد تحت مسمى "الحريات"، انطلاقاً من المبدأ الرأسمالي القائم على فصل الدين عن الحياة وتغليب الفرد على المجتمع.
ونشهد اليوم بداية تدهور الدول المستقرة عندما تفقد الرأسمالية معناها، ويصبح القانون الدولي انتقائياً. فهذه الدول قامت على ثلاث ركائز متلازمة، وقد بدأت جميعها بالتآكل:
- اقتصاد منظم: وهو اليوم شبه مفقود، مع التضخم الكبير وبدايات الركود وصولاً إلى أزمات مالية متتالية، نتيجة المبدأ الرأسمالي نفسه.
- قانون داخلي ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع: حيث اتسعت الفجوة بشكل غير مسبوق، ما سمح بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة.
- الالتزام بالقانون الدولي: الذي تراجع بشكل لافت، لا تجاه الدول التابعة فقط، بل حتى بين الدول المستقلة، في ظل ما تمارسه الولايات المتحدة من عربدة دولية جعلت القانون الدولي في أسوأ حالاته.
وعندما تبدأ الدول بفقدان التزامها بهذه المنظومة، لا تسقط فجأة، بل تدخل في حالة تدهور بطيء، لتصبح دولاً مستقلة اسماً، هشة مضموناً، ومعزولة وظيفياً.
ثالثاً: الدولة المبدئية
وهي الدولة التي تغيّر تربة الفساد، فلا تسمح له بالنمو أصلاً. وهذه الدولة - بصورتها الكاملة - غير موجودة اليوم على الساحة الدولية، لكن هناك من يعمل على إعادتها. وفي المستقبل القريب، بإذن الله، ستظهر لتُري العالم أن الحل كان يكمن في وجودها. إنها دولة الخلافة التي تعتمد المبادئ الإسلامية دستوراً لها، فالإسلام عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام رباني.
الإسلام لا يسمح بوجود الفساد أصلاً، فكيف بتحوله إلى أداة حكم؟ فهناك فرق بين وقوع الفساد بوصفه خطأً بشرياً، وبين شرعنته أو تبنيه.
فالفساد في المبدأ الإسلامي مخالفة شرعية يُحاسَب عليها الإنسان في الآخرة، وتُحاسبه عليه الدولة في الدنيا. وهو لا يقتصر على المال، بل يشمل الظلم، وكسر العدل، وأكل حقوق الناس، وتحويل السلطة إلى غنيمة.
وفي الإسلام، السلطة أمانة وليست امتيازا، ولا وجود لما يسمى "الفساد السياسي"، فالحاكم - خليفةً كان أو والياً - يُحاسَب ويُسأل ويُعزل.
لذلك، فالدولة الإسلامية لا تدّعي العصمة من الخطأ البشري، لكنها تؤسس لحكم لا يتصالح مع الفساد مطلقاً، قائم على رعاية شؤون العباد، وتحكيم الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الإنسان بنفسه، وبربه، وبغيره.
وبمجرد الالتزام بهذا المنهج كنمط حياة، تستقيم الحياة وتعم العدالة، لأن هذا الدين هو وحده القادر على إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ونوره.
بقلم: الأستاذ نبيل عبد الكريم



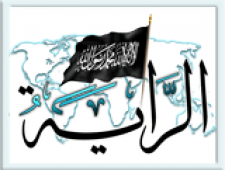

























رأيك في الموضوع