أعادت الحرب الروسية الأوكرانية طرح سؤالٍ جوهري في العلاقات الدولية: هل أصبحت روسيا، بعد مواجهة عسكرية طويلة، دولةً منهكة تآكلت قدراتها، أم أنها باتت أكثر خطورة بعدما كسرت محرمات النظام الدولي؟
ثمّة من يرى أن روسيا تخرج من هذه الحرب مثقلة بالخسائر، تعاني إنهاكاً بنيوياً يحد من قدرتها على الفعل الدولي. في المقابل، يعتبر آخرون أن الحرب أعادت صياغتها كقوة أكثر صلابة وخطورة، وأقل التزاماً بقواعد النظام الدولي، وأكثر استعداداً للمغامرة والتصعيد. ولفهم هذا الجدل، لا بد من التوقف عند التحولات العميقة التي أصابت أدوات القوة الروسية، وموازنة ما خسرته بما ربحته في ميزان الصراع الدولي.
أولاً: ما الذي خسرته روسيا حتى اليوم؟
- الاستنزاف العسكري: خسائر بشرية ومادية ضخمة، واستهلاك واسع للمخزون العسكري التقليدي، مع اعتماد متزايد على صناعات عسكرية تعمل تحت ضغط العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
- الضغط الاقتصادي العام: ناتج عن عقوبات غير مسبوقة استهدفت النظام المصرفي وقطاع الطاقة، ما أدى إلى خروج استثمارات غربية كبرى، وأضعف القدرة على النمو طويل الأمد.
- التراجع في المكانة السياسية النسبية: نتيجة انحسار نفوذها في أوروبا الشرقية، وتوسع حلف الناتو بدل انكماشه، وتحول علاقتها مع أوروبا من أدوات الجاذبية السياسية والقوة الناعمة إلى الاعتماد شبه الكامل على القوة الخشنة.
ثانياً: لماذا تبدو روسيا رغم ذلك أكثر قابلية للمغامرة؟
على الرغم من الاستنزاف، تمتلك روسيا عناصر تجعلها لاعباً أكثر استعداداً للمخاطرة، وذلك لعدة أسباب:
- التحرر من القيود الأخلاقية والقانونية: أصبحت روسيا أقل اكتراثاً بالنظام الليبرالي، وأقل خضوعاً لمنطق المحاسبة الدولية، كما ظهر في سوريا وفي تجاوزاتها داخل الأراضي الأوكرانية، ما شجعها على توسيع قوتها العسكرية وتعزيز حربها السيبرانية.
- تراكم خبرة قتالية طويلة النفس: ساعدت الحرب على إعادة تشكيل العقيدة العسكرية الروسية، ومنحتها خبرة ميدانية تفتقر إليها كثير من الجيوش الأوروبية.
- التحول من السعي للقيادة إلى التقويض: لم تعد روسيا تطمح إلى قيادة النظام الدولي، بل تعمل على تقويضه، انطلاقاً من قناعة بأن هذا النظام بات أقل قدرة على الهيمنة، وأكثر قابلية للإرباك، وهي مستعدة للتكيف مع أي انتقال من الأحادية القطبية إلى التعددية أو حتى الفوضى.
- التوسع في ساحات بديلة: تتجلى خطورتها في قدرتها على التصعيد غير المباشر مع أوروبا، والانخراط في ساحات بديلة كأفريقيا، والشرق الأوسط، والقطب الشمالي.
ثالثاً: روسيا كقوة جريحة لكنها عنيدة:
روسيا اليوم ليست الاتحاد السوفيتي البائد، ولا الدولة المنهارة. إنها قوة جريحة لكنها عنيدة؛ فقدت جزءاً من قدرتها على السيطرة، لكنها ربحت استعداداً أعلى للمخاطرة. وفي عالم يتجه نحو "فوضى منظَّمة"، قد لا تكون أخطر القوى هي الأقوى، بل تلك التي لم يعد لديها ما تخسره.
وعليه، لا ينبغي النظر إلى روسيا كقوة صاعدة، بل كقوة تحاول منع تراجعها. فهي تمتلك السلاح والردع، وتسعى إلى توسيع مناطق نفوذ هشّة برضا الرعاة الإقليميين والدوليين. ورغم ضعفها الاقتصادي والتكنولوجي وتراجع التنمية البشرية بفعل العقوبات، تبقى العقلية الروسية عامل خطورة، وإن كانت محدودة الآفاق.
روسيا اليوم لاعب مزعج، وشريك تكتيكي لا قائداً استراتيجياً. فقوتها تكمن في قدرتها على منع الآخرين من تحقيق نصر كامل، لا في فرض نصر خاص بها، بينما يتمثل ضعفها في غياب مشروع عالمي يتجاوز منطق الصدام.
رابعاً: روسيا في عالم متعدد الأقطاب:
في عالم ما بعد الأزمات الكبرى المقبلة، قد لا تكون روسيا القوة التي تقود المستقبل، لكنها بلا شك إحدى القوى التي ستسهم في أي تسوية دولية قادمة.
ففي حال تحوّل النظام الدولي من الأحادية القطبية إلى التعددية، أو حتى إلى شكل فوضوي، فإن التعددية القائمة على توازن القوى لا على هيمنة مركز واحد تنسجم مع الرؤية الروسية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.
تعددية الأقطاب تقلل من قدرة الغرب على عزل روسيا أو فرض عقوبات خانقة عليها، ويعود السلاح النووي ليكون أداة مركزية لضمان المكانة الدولية. كما تجيد روسيا العمل عبر تحالفات غير مبدئية مع الصين وإيران والهند ودول أفريقية. وفي نظام كهذا، تزداد الحاجة إلى قوى قادرة على التوسط أو التعطيل، وروسيا بارعة في الأمرين.
لذلك، في نظام متعدد الأقطاب، ليست روسيا القطب الأقوى، لكنها قطب ضروري لا يمكن تجاوزه. فحظوظها لا تكمن في قيادة النظام الدولي، بل في منع تشكّل نظام معاد ومستقر ضدها، وفي المنافسة على المكانة والتأثير والتعطيل، في عالم يتجه إلى تعددية غير مكتملة أو فوضى مُدارة.
خامساً: هاجس الدولة الإسلامية في العقل الروسي:
الخوف الحقيقي لدى روسيا لا يتمثل في قوة عسكرية تقليدية، بل في احتمال قيام دولة إسلامية ذات طابع مبدئي عابر للحدود. فداخل روسيا ما بين 20 و25 مليون مسلم (في الشيشان، وداغستان، وإنغوشيا، وتتارستان وغيرها)، وقد يمنح قيام مثل هذه الدولة شرعية رمزية لحركات إسلامية تطالب بالانضواء ضمن الكيان السياسي الناشئ.
كما تتخوف روسيا من جوار دولة لا تعترف بحدود الدولة القومية كما تفهمها، إذ لا تراها مجرد كيان سياسي جديد، بل نموذج شرعية بديلا قادرا على اختراق حدودها القومية، وإعادة إحياء أسئلة الهوية والولاء داخل فضائها الداخلي الهش.
من هنا، تفضّل روسيا دعم أنظمة سلطوية قابلة للضبط، على المجازفة بقيام دولة تستمد شرعيتها من خارج المنظومة القومية الحديثة. فمخاوف موسكو ليست مما قد تفعله هذه الدولة خارجياً، بقدر ما تخشاه من آثار قيامها داخلياً.
وعليه، فإن معركتها الحقيقية ليست مع الإسلام كدين، بل مع احتمال ولادة نظام سياسي لا تستطيع احتواءه أو التحكم به. وفي عالم تتآكل فيه الحدود، يبقى هذا الاحتمال هو الكابوس الاستراتيجي الأكبر في العقل الروسي.
ولهذا تُفهم حملات الاعتقال الواسعة ضد شباب حزب التحرير في مناطق مختلفة من روسيا، دون تمييز بين الرجال والنساء، إذ إن المواجهة هنا ليست أمنية فحسب، بل فكرية، تستهدف فكرة دولة تحمل مفهوم الأمة، ولا تؤمن بالحدود أو بالقانون الدولي القائم، وتسعى إلى إعادة المجد الإسلامي كما كان، أو كما بشّر به رسولنا الكريم ﷺ.
بقلم: الأستاذ نبيل عبد الكريم



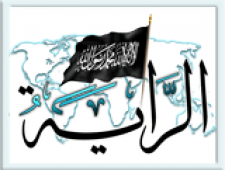






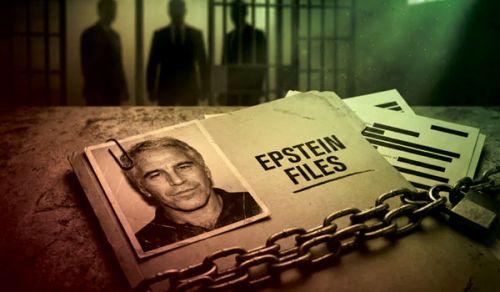






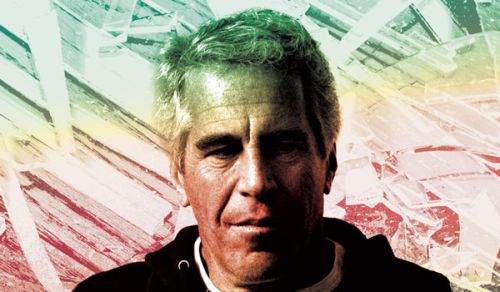











رأيك في الموضوع