ليس كل من أيّد شخصاً كان فاسد النيّة، ولا كل من دافع عن قائدٍ كان شريكاً في خطئه؛ فكثير من الناس يُضَلَّلون بحسن الظاهر وقوة الخطاب، ويقعون في الاغترار دون قصد. إلا أن المشكلة لا تبدأ من حسن الظن، بل من الإصرار عليه بعد تتابع القرائن، ومن تحويل الأشخاص إلى قضايا مقدّسة لا تُناقش ولا تُراجَع.
ولا يصح هنا الاحتجاج بصعوبة الظروف أو طبيعة المرحلة، لأن هذا التبرير نفسه هو الذي استُعمل عبر التاريخ لتبرير أعظم الانحرافات. فلو كان تغيّر الظروف مبرراً لتغيير الأصول، لما بقي في الأمة أصلٌ ثابت، ولما كان للثبات معنى، ولا للتضحية قيمة.
إن الواجب الشرعي والأخلاقي يقتضي أن يُوزن كل شخص بميزان واحد لا يتغير: ماذا قدّم للمبدأ؟ ماذا غيّر فيه؟ إلى أين يقود الناس؟ ومع من ينسّق؟ وعلى أي حساب تكون التنازلات؟ فإذا كانت الإجابات تثير القلق أكثر مما تبعث الطمأنينة، فالصمت حينها ليس حكمة، بل تواطؤ غير مقصود.
إن الاعتراف بالخطأ ليس سقوطاً، بل نجاة. أما الاستمرار في تبرير المسار الخاطئ خشية انهيار الصورة، فهو الطريق الأقصر لتحويل الخديعة الفردية إلى كارثة جماعية. فالحق لا يُعرف بالرجال، ولكن الرجال يُعرفون بالحق، ومن خالفه سقطت عنه كل الزخارف مهما علت كلماته.



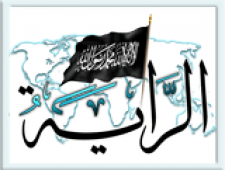






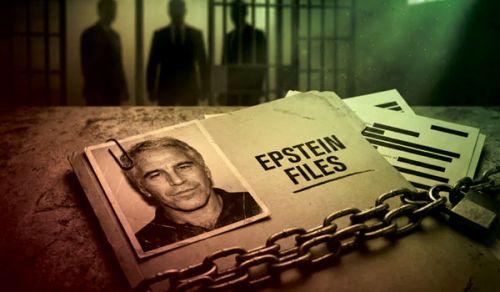






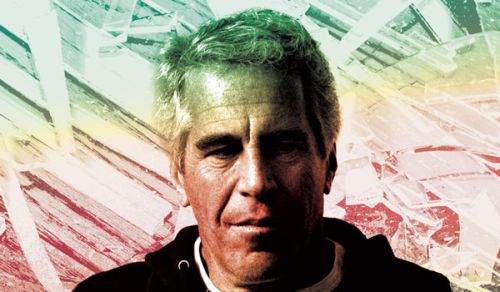











رأيك في الموضوع