في أوج مراحل ضعفها تعرضت الأمة الإسلامية إلى هجمة غربية شرسة انتهت بدخول الاستعمار الفرنسي البغيض إلى الأيالة العثمانية في تونس سنة 1881، هذا الاحتلال كان ثمرة توافق أوروبي صامت أو مقايضة مستعمرات إثر مؤتمر برلين عام 1978، حيث عبّر المستشار الألماني بسمارك في أكثر من مناسبة عن أن تونس ضعيفة ومفلسة وبلا حماية حقيقية وأن فرنسا يمكن أن تأخذها دون صدام أوروبي.
بعد استتباب الأمن وخمود حركة المقاومة، جاءت اتفاقية المرسى المشؤومة سنة 1883م بين المقيم العام الفرنسي وعلي باي لتكرس النفوذ الغربي والخضوع التام للاستعمار بجميع مستوطناته الفكرية والسياسية والقانونية.
لم تغيّر وثيقة إعلان الاستقلال عام 1956من الوجه الاستعماري القبيح سوى شكله، حيث ولدت الدولة الوطنية في كامل المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب) بولادة مشوّهة، إذ لم تنشأ نتيجة تعاقد مجتمعي داخلي، بل كوارثةٍ إدارية للدولة الاستعمارية، بحدود رسمها الاستعمار ونخب تشرّبت منطق الدولة المركزية الضابطة. أنتجت هذه الولادة دولة قوية شكلياً بمجتمع سياسي ضعيف، تستمد شرعيتها من ركائز أحادية: التحرير في الجزائر، والملكية التاريخية في المغرب، والتحديث البيروقراطي في تونس.
التراكمات التي أحدثها فساد مشروع دولة الحداثة في نظام بورقيبة الذي أحدث تصادما حادا مع هوية الأمة وطريقة عيشها، لتليها سياسة تجفيف منابع التدين خلال حكم بن علي ما ولد احتقانا لدى الأجيال، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية والسياسية حيث قدرت الأموال المنهوبة إبان الثورة بـ49 مليار دولار، فكانت الوضعية كافية لإشعال فتيل ثورة عارمة، خرج الناس على النظام الذي أفرز كل هذه الكوارث وكان مطلبهم واضحا فيما عرف بأيقونة الشعب العربي: "الشعب يريد إسقاط النظام"، للقطع مع النظام القديم لصالح نظام جديد وإن لم يتبلور شكله.
المثال التونسي ليس بالاستثناء عن سائر الأنظمة في بلاد الثورات، صراع حضاري عبرت عنه الأمّة في جميع المحطات وتصدت لكل مشاريع التغريب، وما حالة عدم الاستقرار الذي نعيشه إلا تعبيرا صادقا من الأمة عن رفضها إعطاء قيادتها طوال 15 عاما من الثورة لمن لم يمثلها عقديا ويقود صراعها الحضاري مع الاستعمار.
قوّة الاستقطاب الخارجي ومخططاته:
من البديهي أن المستعمر لن يترك البلاد لأهلها بمجرد احتجاجات شعبية، مسايرة الغرب للثورات كانت على مضض وفي منطقة ذات حدود واضحة؛ فهو لا يدعم التغيير ضد الدولة القائمة، بل داخل سقفها، ولا يقبل إعادة تعريفها أو تفكيكها. حتى الديمقراطية الغربية حين تهدّد سيادة الدولة أو مركزية القرار، يُفضّل الاستقرار.
بعد سقوط بن علي، عملت القوى الغربية على توجيه المسار الثوري منذ البداية، عبر آليات واضحة. فقمة دوفيل في أيار/مايو 2011 مثلت الإطار العام لهذا التوجيه، حيث تم ربط الدعم المالي الموعود لإدارة المرحلة الانتقالية والتأسيسية بشروط صارمة، أهمها الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموروثة وبرامج المؤسسات المالية الدولية. بل إن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد التونسي تم رسم توجهاته من دوائر غربية، كما اعترف البنك المركزي بوجود ممثلين أجانب في لجنته الاستراتيجية العليا.
هندسة النظام السياسي من الخارج والداخل:
تمت هندسة المشهد السياسي التونسي الجديد بآليات تصميمية شارك فيها فاعلون خارجيون ونخب محلية موالية. فمن الناحية الدستورية، كان للأطراف الدولية دور مباشر، حيث نذكر حضور نوح فيلدمان المستشار الدستوري الرئيسي للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق أثناء صياغة دستور 2014، كما أكد آزاد بادي نائب المقرر العام للدستور في المجلس التأسيسي، أن فصول الدستور كانت تأتي من قصر الضيافة بالمرسى. ومن الناحية الانتخابية، اعتمد نظام القوائم النسبية المعقدة عام 2011 لضمان تمثيل واسع وغير مستقر، ثم تغير النظام عام 2014 لصالح القوائم الحزبية الكبيرة ما مكّن صعود نداء تونس والنهضة، وهو تحول جاء بعد اللقاء التوافقي الشهير في باريس بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي. إضافة إلى ما حدث من تعكير الأجواء بالأعمال الإرهابية والاغتيالات السياسية طوال المسار التأسيسي.
لم يُفضِ التوافق الوطني بين القوى الكبرى إلى استقرار، بل دخلت البلاد في طريق مسدود تحت شعار "لا أحكم ولا أنت تحكم"، وسط صراع داخلي وضغط خارجي لإمضاء اتفاقيات مثل "الأليكا" الشراكة الشاملة والمعمقة مع الاتحاد الأوروبي.
أدى استياء الشعب من فشل النخبة السياسية والتوافقات المفضوحة إلى تمهيد الطريق لقيس سعيّد، الذي أنهى المسار التوافقي بعد 25 تموز/يوليو 2021 وعاد بالدولة إلى نموذج الفاعل الأحادي بخطاب سيادي شعبوي. هذه العودة السلطوية لم تواجه معارضة غربية حقيقية، بل قوبلت بقبول واقعي، خاصة من فرنسا والولايات المتحدة، لأنها ضمنت الاستقرار وحافظت على البنية الأساسية للدولة والمصالح الجيوسياسية.
المطلوب للخروج من الأزمة:
الحال لم يتغير ما دام الاستعمار نفسه قائما ومتحكّما، التغيير لا بدّ أن يكون جذريا مستهدفا المستوطنات الفكرية والسياسية والقانونية التي وضعها المستعمر في بلاد المسلمين، والتي ولّدت أزمات سياسية خانقة من فرقة وسجون وتنكيل بالخصوم وأزمات مجتمعية لم يشهدها المسلمون على مرّ تاريخهم، وتخلّف شامل، كل هذا العبء يحتاج مشروعا جاهزا معبّرا عن فكر الأمّة وحسّها ينطلق من عقيدتها ووجهة نظرها في الحياة.
مشروع التغيير أثقل من الدولة الوطنية، وهذا ما عبرت عنه الثورات وامتداداتها في جلّ الدول العربية، وهذا يحتاج فكرة جديدة عن مفهوم الحكم والدولة نابعة من الإسلام؛ الدين المكتمل والمكتفي بذاته، وإلى قائد فذّ تتوفر فيه شروط القيادة وإلا كان مصير العملية الفشل كما حصل لثورة تونس حين تسلمها وقادها الطفيليون الخونة الانتهازيون.
كذلك تحتاج عملية التغيير أن يقودها تكتل سياسي مبدئي يقوم على عقيدة الأمة، هاضم لفكرته، مدرك لغايته. وحتى يتفادى مصير سائر التجارب التي مرت بها الأمة، لا بد أن يتوفر فيه أمران:
1- أن يكون هذا التكتل حزبا قائما على عقيدة الناس، أي عقيدة الإسلام، يتولى عملية تثقيف الأمة بالثقافة الإسلامية لصهرها بالإسلام، وتخليصها من العقائد الفاسدة والأفكار الخاطئة، والمفاهيم المغلوطة، ومن التأثر بأفكار الكفر وآرائه.
2- أن يعمل على أن يصبح الإسلام هو المطبق، وتصبح عقيدته هي أصل الدولة، وأصل الدستور والقوانين فيها. لأن عقيدة الإسلام هي عقيدة عقلية، وهي عقيدة سياسية انبثق منها نظام يعالج مشاكل الإنسان جميعها؛ السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية...
هذه المواصفات لا تتوفر اليوم إلا عند حزب التحرير الذي نذر نفسه وشبابه لإيصال الإسلام إلى الحكم وليس إيصال المسلمين إلى الحكم. فكم من مسلم اعتلى سدة الحكم لكنه حارب الإسلام واصطف مع أعدائه! فالفرض اليوم هو استئناف الحياة الإسلامية، ولا يتأتى ذلك إلا بإقامة الخلافة على منهاج النبوة.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
بقلم: الأستاذ ياسين بن يحيى



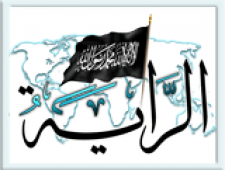






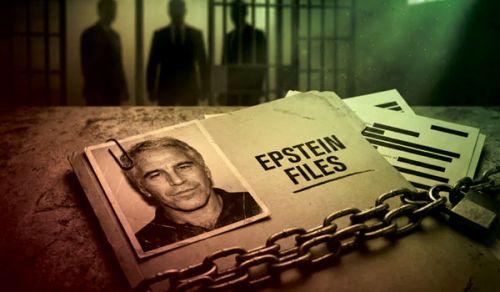






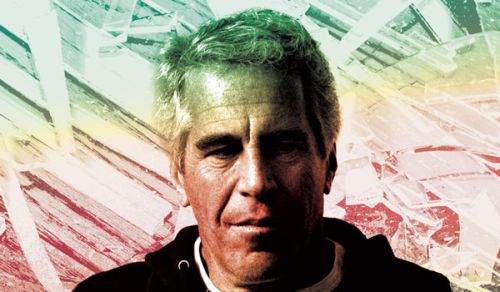











رأيك في الموضوع