(مترجم)
تم الاحتفاء بقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) السابعة والأربعين، التي عُقدت في كوالالمبور في الفترة من 26 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2025، باعتبارها انتصاراً للوحدة الإقليمية تحت شعار "الشمولية والاستدامة". إلا أن الاجتماع، رغم الخطابات المنمقة والمصافحات الاحتفالية، كشف عن استمرار خضوع دول جنوب شرق آسيا - وخاصة ذات الأغلبية المسلمة - للنظام العلماني الرأسمالي للسياسة العالمية. فبدل أن تكون احتفالاً بالاستقلال، أظهرت القمة كيف أن رابطة آسيان لا تزال آلية للهيمنة الخارجية وليست آلية لتحرير الأمة، وهذا على الرغم من أن ماليزيا، البلد الإسلامي، هي المضيفة.
كان حضور ترامب القمة أوضح رمز لهذا الواقع. فجولته الآسيوية، التي تزامنت مع القمة، وُصفت علناً بأنها مهمة "لاستعادة الحرية والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". خلف هذا الغطاء الدبلوماسي، يكمن هدف أمريكا الأعمق وهو استعادة نفوذها المتراجع عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع الشركاء الملتزمين. ما وصفته وسائل الإعلام بالدبلوماسية هو في الحقيقة تجديد للسيطرة الاستعمارية الجديدة عبر الاتفاقيات والابتسامات.
خلال القمة، وقّعت ماليزيا اتفاقيتين رئيسيتين مع أمريكا؛ الأولى: اتفاقية التجارة المتبادلة بينهما، تُلزم ماليزيا بمشاركة البيانات الجمركية، ومواءمة ضوابط التصدير، ومواءمة المعايير المحلية مع اللوائح الأمريكية. أما الثانية: فهي مذكرة تعاون دفاعي جديدة ضمن إطار أمن المحيطين الهندي والهادئ، تُدمج ماليزيا بشكل أعمق في الشبكات العسكرية التي تقودها أمريكا.
يتم تسويق هذه الخطوات على أنها خطوات نحو "التحديث" و"الشراكة الاستراتيجية"، في حين إن الاتفاقية التجارية في الواقع تضع سيادة ماليزيا فعلياً تحت إشراف أمريكا، ما يمنح أمريكا نفوذاً على السياسة والبيانات وتدفق الاستثمارات. هذا النوع من الخضوع يتناقض مع الأمر الإلهي ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.
ومن خلال إضفاء الطابع المؤسسي للرقابة الأجنبية على اقتصادها، تمنح ماليزيا "السبيل" الذي حرمه الله. إنها تقايض الاستقلال بالوصول إلى الأسواق التي تديم التبعية.
والأشد إثارة للقلق هي مذكرة الدفاع، فهي تسمح لأمريكا - آلة قتل المسلمين - بالمشاركة في تدريب ماليزيا واستخباراتها ولوجستياتها. بموجب الشريعة الإسلامية يَحرم طلب الحماية أو التحالف من الدول المعتدية المحاربة فعلا، لأنه يضع أمن المسلمين في أيدي من يقوضونه، يقول سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾.
إن دمج نظام دفاع الأمة الإسلامية في نظام دفاع المعتدي الاستعماري يعد انتهاكاً مباشراً لهذا الأمر. وكما تشير منظمة الدفاع والأمن الآسيوي 2025، فإن مذكرة التفاهم تسمح لأمريكا بتوسيع الوصول إلى الموانئ والمجال الجوي الماليزي تحت ستار "بناء القدرات". هذه القدرات لا تؤدي إلا إلى تعزيز النفوذ العسكري الأمريكي في جميع أنحاء المنطقة، باستخدام ماليزيا كعقدة استراتيجية في منافستها مع الصين. هذا ليس تعاوناً؛ إنه استسلام. من منظور الشريعة الإسلامية - وهو بُعد لم تدرسه ماليزيا - يمثل هذا التحالف شكلاً من أشكال التعاون المحرم صراحةً، لأنه ينطوي على التعاون مع أولئك الذين يحاربون الله ورسوله ﷺ.
أبرز حضور ترامب توقيع اتفاقية كوالالمبور للسلام بين تايلاند وكمبوديا طموح أمريكا في وضع نفسها كحكم إقليمي للسلام. ومع ذلك، يثبت التاريخ أن "السلام" الذي توسطت فيه أمريكا هو آلية للحفاظ على نفوذها، وليس العدالة. وكل مصافحة تتم تحت علم أمريكا تربط المنطقة بشكل أوثق بالهيكل العالمي للتبعية.
يبدو الشعار الرسمي للقمة "الشمولية والاستدامة"، فارغاً من أي مضمون. في الخطاب المعاصر، أصبح الشمول يعني المشاركة ضمن أطر التجارة والأمن التي وضعها الغرب، بينما تعني الاستدامة الحفاظ على نظام رأسمالي قائم على تفاوت هيكلي. تُبرز مشاركة ماليزيا في مثل هذه الترتيبات حقيقةً مُقلقة: لم تفعل البلاد الإسلامية ما بعد الاستعمار سوى تحسين آليات التبعية. وبقبولها هذه الشراكات، فإنها لا تتخلى عن السيادة المادية فحسب، بل تتخلى أيضاً عن الفاعلية الأخلاقية.
من المنظور الإسلامي، ليس معيار النجاح الاستثمار الأجنبي، أو نمو الناتج المحلي الإجمالي، أو التصفيق الدبلوماسي، بل طاعة الشريعة الإلهية والاستقلال عن الطاغوت. وقد حذّر النبي ﷺ: «مَنِ اسْتَجَارَ بِقَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواه أبو داود، كتاب الجهاد. تُشبه تحالفات ماليزيا الجديدة هذه التبعية المحرمة تماماً.
لا يمكن للسيادة الحقيقية أن تتعايش مع الخضوع. لا يُقر الإسلام إلا بشكل واحد من أشكال الأمن الجماعي وهو ما ينشأ عن وحدة المسلمين في ظل حكم الشريعة. وقد حمت الخلافة دهرا طرق التجارة، وأمنت البحار، وضمنت العدالة دون الاعتماد على أساطيل أو قروض أجنبية. لقد استمدت قوتها من الإيمان وتطبيق الشريعة الإلهية، لا من المواثيق مع الكفار.
تصف البلاد الإسلامية اليوم هذه القيم بأنها "غير واقعية"، ومع ذلك، فقد كان هذا النظام تحديداً هو الذي وحّد أرخبيل الملايو يوماً ما تحت حضارة واحدة. إن العودة إلى الحكم الإسلامي ليست حنيناً إلى الماضي، بل إنه ضرورة. فبدونه، ستظل البلاد الإسلامية تتأرجح بين واشنطن وبكين، بين الاعتماد على الأسواق الرأسمالية والخوف من الإكراه العسكري.
قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾. تُجسّد هذه الآية جوهر السيادة السياسية في الإسلام: الحكم لله وحده. أي قانون أو معاهدة أو تحالف يمسّ بهذا المبدأ يُعتبر باطلاً، بغض النظر عن الإشادة الدبلوماسية.
وهكذا، تُمثّل قمة آسيان السابعة والأربعون أداءً سياسياً واتهاماً أخلاقياً في آنٍ واحد. فهي تُظهر كيف أخطأت الحكومات ذات الأغلبية المسلمة في الخلط بين العبودية والرقي. فبينما تدّعي الحياد بين القوى العظمى، تتأرجح في الواقع بين صنمين - المادية الرأسمالية والقومية العلمانية - وكلاهما بعيدٌ عن الهداية الإلهية. ولن تستعيد هذه المنطقة كرامتها إلا برفض هذه الأصنام وإعادة إرساء حكم الوحي.
إلى أن يحدث هذا التحول، سيظل "الشمول" كنايةً عن التبعية، وستعني "الاستدامة" الحفاظ على هياكل الظلم ذاتها التي تُبقي الأمة منقسمةً وضعيفة. ويقدم القرآن التذكير والتحذير النهائي: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ﴾.
ولا شك أن إعادة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على إعادة القوة الحقيقية والكرامة والاستقلال والعدالة للبلاد الإسلامية. وفي ظل هذا النظام الإلهي، تتوحد قوة الأمة السياسية والاقتصادية والعسكرية تحت قيادة واحدة تحكم بالوحي، وتواجه الظلم عالميا، وتحمي مصالح الإسلام عبر كل الحدود. وهذه القيادة وحدها هي القادرة على إنهاء التشرذم الذي يفرضه نظام الدولة القومية وإحياء حضارة تسترشد بـ"رحمة للعالمين" رحمة للبشرية جمعاء.
بقلم: الأستاذ عبد الحكيم عثمان
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ماليزيا



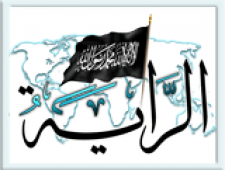






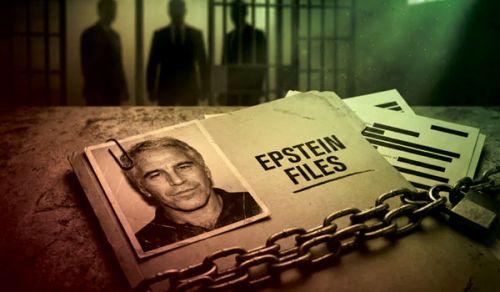






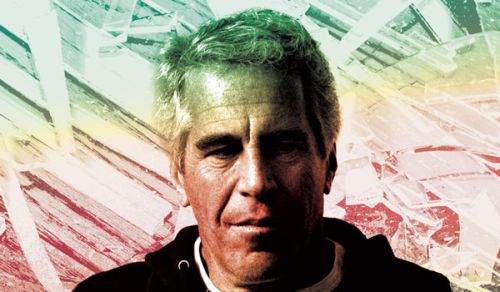











رأيك في الموضوع